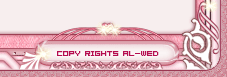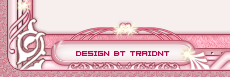والدي رجل لا يهتمُّ لأبسط طلبات أبناءه الأبرياء ، فأنا منذ أن كنت في الابتدائية لا أذهب للمدرسة إلا مشياً على الأقدام ، مُحاطاً بمواء القطط ، وصراخ الأمهات في البيوت المحيطة محاولة منهن لإيقاظ أبنائهن للمدرسة ، لا زلت أذكر طريق المدرسة الابتدائية بالرغم من تغير معالم تلك الحارة ، فأنا أذكر أنّي أحمل كتبي صباحاً وأتأبطهن – فأنا لا أملك حقيبة مدرسية - ، وآخذ القلم الرصاص الصغير جداً وأضعه في جيبي الأيمن ، وأضع في جيبي الأيسر رغيف صامولي حُشي بالجبن وكثيرة هي المرّات التي أصل فيها للمدرسة وأنا لا أملك رغيفاً ، ثم تطبع والدتي قبلة على جبيني الأشهب قائلةً ( الله يحفظك يا وليدي )* ، أنزل من درجات المنزل الكبيرة والمتباعدة جداً ، أصل للباب وأقف على أطرف أصابع القدمين وأفتحه ، أخرج وأتجه للمدرسة ، بطاولاتها القديمة المتراصة ، بسبورتها السوداء القاتمة المشروخة ، والطباشير الأبيض القليل المقضوم ، والأبواب الخشبيّة المتهالكة التي حُفر عليها ذكريات لقوم عادٍ وثمود ، ومُدرسيها الذين أعتبرهم كبقيّة أثاثها لما لهم من تواجد دائم وأبدي ، والحديقة الصغيرة المليئة بالخضراوات ، وسياجها الخشبيّ الأخضر ، وأغصان النخيل الداكنة الخضرة التي لم تجد حتَّى الآن أحداً يُلقحها .. !! ، لا زلت أذكر البائع اليماني في الدكان ( أبو سعيد ) الذي لا يُعري للسروال القصير أدنى اهتمام بعدم لبسه إيّاه ، أذكر بالتحديد عدد المرات التي سرقت منه حلاوة ( برميت ) ، وأذكر عدد المرات التي وبخني فيها جدّي بسبب تلك السرقة .
تفاصيل حياتي القديمة محفورة في داخلي كمدينة قديمة تستحمُّ في أشعة الشمس الملتهبة وتبدو كأنها ترجِّع صوتها كالأرغن ، الشخصيّات القديمة في تلك المدينة لا تزال تزورني بين الفنية والأخرى ، وأشكالهم كأول مرة رأيتهم فيها ، بالرغم من أنَّ (المدرسة) و ( بيتنا ) قد هُدما و ( أبو سعيد ) و (جدي) و (بعض المدرسين) قد توفاهم الله .
فما هي الحاجة لذكراهم الآن ، ومالها نفسي تُدمدم علي ذكراهم مثل خفقات الدفء .. !!
لا أدري لماذا .. ولا المُنجمُ يدري .. !