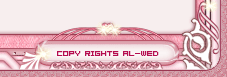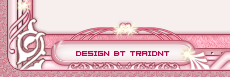في الحقيقة كُنت – ولا زلتُ – أتربع على رأس هرم الغلابى ، ولكنني لم أعي ذلك إلا متأخراً ، خصوصاً عندما أدركتُ أنَّ الرطل يساوي نفس سعر الكيلو بالرغم من أن الرطل يساوي 2,5 كيلو تقريباً ، فلعنة الله على المكيال وعلى العثيم ! ؛ أريد أن أطمس بعض سنوات العُمر ، خصوصاً تلك الفترة التي كان عمري فيها ما بين – 8 سنوات إلى 18 سنة - ، أريد أن أُقطِّع نفسي إرباً إربا نظير أفعالي وقتها ، بالتأكيد سأحتاج إلى خرّيج إدارة أعمال ليحسب لي عدد – الطراقات*- التي تلقيتها في تلك الفترة من العمر ، بالرغم من أنَّ تأثيرها معدوم ، حتّى أني أحياناً أتجه لوالدي بعد الفِعلة وأقف أمامه مقدماً خدّي على صينية من ذهب قائلاً ( هَهْ ، أخلص ) !! ، لم يكن الضرب وقتها أمراً بالغ الأهميّة كما هو الآن ، كان الكل يُضرب ، حتى المتزوج كان ينال نصيبه من الضرب ، أما الآن فرب البيت بحاجة إلى حجة عظيمة كي يتفوه على ولده – متهوراً – ويقول ( يا ولدي ، أعقل ) ، لم تعد التربية الأسرية كما كانت ، فالأولاد تمردوا وكربوا من نيل راية الأمارة في كل بيت ! .
لا أعلم لماذا أنا غلبان ، ولا أريد وصف الشعور الذي يداخلني عند رؤيتي لابن مكتوم مثلاً وهو يعتمرُ الغُتره الصوف ، أو الإحساس الذي يباغتني عند رؤية أسعار النفط ، لكنني على يقين بأن الله قد مهد طريقي إلى الجنّة بجعلي غلباناً أحلم كل ليلة بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يُصرف لكل مواطن راتب شهر أو قسيمة اشتراك مجانيّة لغسيل الملابس ! ؛ لكن الذي لا أستطيع التوقف عن التفكير فيه هو أصدقائي الذين ساروا معي على طريق الغلابى ثم انعطفوا مع أول مفترق طرق ليسيروا في طريق الرفاهية ؛ صديقي عبد العزيز الذي لا زلتُ أذكره جيّداً ، وأذكر حتَّى آخر ليلة جاء فيها إلى المملكة العربية السعودية قادماً من كندا لأستقبله في المطار وأحضره – فوراً – إلى صلبوخ ( حيث كُنّا نخيّم ) ، ليروي لي حكايته مع تشيسكا وحدائق مونتريال ، وبعد العشاء أوصلته إلى بيته في حيَّ الفلاح وقلت له ( باكر أن شاء الله نشوفك ) ، كم أتمنى أني قلت وقتها ( باكر أن شاء الله أشوفك ، أحرص تكفى على بكرة ) ، لأن عبد العزيز غادر في اليوم التالي عائداً إلى كندا ، لتنقطع أخباره بعدها حتّى عن أهله ، وله الآن 12 سنة – لا حسّ ولا خَبر - ، لا أدري في ماذا كان يفكر عبد العزيز وهو يتسلل خارجاً من بيتهم ، ويحمل حقيبته – الكروهات - ، ولا أعلم بأي يد هو أشار لسيّارات التاكسي في الشارع العام !! .
ليس عبد العزيز هو محور الحديث أبداً ، ولا يهم خبره ، لكن عبد العزيز كان من القلائل – إن لم يكن الوحيد – الذين أثروا على حياتي أيما تأثير ، سواء بفعلته الأخيرة هذه ، أو بماضيه معي ! .
فلم أتلمظ لأجل مشاهدة الأفلام إلا من خلاله ، ولم أدفع 10 ريالات لحضور المباريات عصراً تحت شمس الرياض الشاوية إلا معه ، حتّى أني أدمنت – الحَب الخَانس – بسببه ، ولم ألبس أي بنطلوناً في حياتي قبله ، ولم أتفوّق دراسياً إلا بجهده ، فقد كان يأخذ ورقة الإجابة خاصتي ليحلها أولاً وبعدها يحل لنفسه !! ، كان شهماً لا تبدو عليه آثار هذه الشهامة ، مؤدباً لدرجة الجاذبيّة ، حاضر النكتة ، وسريع البديهة ، كان كاملاً – ولا كامل إلا وجهه تعالى – لو تخلا عن المزاجية .
المهم في الأمر هو مفترق الطرق الذي سلكه عبد العزيز ، وتركه إياي أكمل المسير على طريق الغلابى الصحراوي ! ، ليس عبد العزيز أول من يفعلها ، وبالتأكيد لم يكن الأخير ، فجميع أصدقائي قد سلكوا نفس مفترق الطرق ذاك ، فبعضهم يدرس الآن في الخارج ، وبعضهم الآخر يحتل تلك المناصب التي لا تستطيع الحديث مع أصحابها إلا ببصمة صوت وإصبع ! ، وبقيت وحيداً على طريق الغلابى الموحش .
لا أستغرب بقائي حتى يومنا هذا على طريق الغلابى ، فقد تعمدت أكثر من مرة تفويت الفرصة على نفسي لأجل بعض الشهوات الوقتيّة ، كمشاهدة فريق النصر ! ، والاجتماع بأصدقاء السوء مساء كل يوم ! ، والتلذذ بما يقدمه مطعم ميرا البخاري ! ، وانتظار مواسم الإثمار لشجرة العبري ! ، لعل انتمائي لفئة الغلابى هذه لم يمنعني قطّ من التمني كل يوم ، ودعاء ربي بعد صلاة ، بأن يكون أبي يملك أرضاً في حيّ لبن ، أو عمارة في شارع الستين ، أو رصيداً في البنك يجعل موظف خدمة العملاء الذي أحضره – أي أبي – يأخذ ( بونص ) سنوي يتجاوز ال 400 ألف ريال ! ، أتمنى ذلك وأرجو ألا أعرف أبداً لأن المفاجئة ستكون مفجعة بالنسبة لي في كل الأحوال .