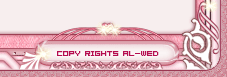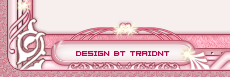يعيش المؤمن حياته بين مخافتين: حزن على ما مضى ووقع، وخوف وإشفاق مما يأتي، وهو بين هاتين المخافتين يحمل قلباً كسيراً حزيناً، وهماً وكرباً ثقيلاً، ولا يفارق ذلك إلا عندما يعايش الموت. فكيف كان ذلك؟
هم الذنوب والمعاصي:
الهم الأول للمؤمن في الحياة هي ذنوبه ومعاصيه، وما سلف منه من تفريط في حق الله تعالى، والذنب عند المؤمن كبيرة وصغيرة، كبير، فهو لا ينظر إلى كبر الذنب وصغره، ولكنه ينظر إلى من عصى، ويعلم أنه كلما ارتقى في سلم الإيمان كلما عظم الذنب في حقه، فالصغيرة من الكبير كبيرة، والهفوة من العظيم عظيمة!!
ألا ترى الرسل كيف كانوا يعدون على أنفسهم ذنوباً لو كانت لنا لحسبناها طاعات، ولاتخذناها قربات، فمن منا لا يتمنى أن يكون هو الذي قال ما قال إبراهيم عليه السلام: {إني سقيم} {بل فعله كبيرهم هذا} ليحطم أصنام القوم {وهذه أختي} ليحمي امرأته من جبار، ولكن إبراهيم يقول يوم القيامة: [إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات]!!
ومن منا لا يرجو أن يكون دافع عن مظلوم كما فعل موسى، الذي قتل عدواً بطريق الخطأ، ومع ذلك يقول عليه السلام [ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي] ويقول يوم القيامة: [إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، فقتلت نفساً لم أومر بقتلها].
ومن منا لا يرجو أن يدعو على أهل الشر والفساد والكفر والعناد أن يستأصلهم الله من الأرض ويريح البلاد والعباد من شرورهم فيقول: [رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً]
ويظن أن دعاءه هذا قربة يتقرب بها إلى الله، ولكن نوحاً عليه السلام يذكر ذلك ويؤرقه ويظل خائفاً من دعائه هذا الذي استجابه الله له، ويقول لمن طلب منه الشفاعة: [إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، فدعوت على قومي]..
[c]ومن منا له عمل صالح، ومنزلة عالية كما لخاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الناس أجمعين، ومع ذلك فقد قال له رب العالمين: {ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك} وقال تعالى له: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً}. [/c]
وهل يتصور للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من ذنب إلا أن يكون شيئاً فعله خلاف الأولى!!
والخلاصة أن المؤمن يرى الذنب أكبر وأشمل مما يراه من لم يعرف حقيقة الإيمان، ويحس بوطأة ذنوبه، وإن كانت صغائر كأنها جبل يوشك أن يقع عليه، وأن الله إن لم يغفرها له ليكونن من الخاسرين، قال صلى الله عليه وسلم: [المؤمن يرى معصيته كجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى معصيته كذباب وقع على أنفه]!! وما أسهل الذنب عند من يرى أن مثله مثل ذباب، وهل أسهل من أن يذب الإنسان عن نفسه ذبابة، ويبعدها عنه، وما أثقل الذنب عند من يرى أن ذنوبه كالجبل الجاثم فوق رأسه وصدره، وهم دائم التفكير في كيفية إزاحته عنه.
والذنب يتسع عند المؤمن، لأنه يعلم أن غفلة ساعة عن ذكر الله ذنب، وفوت نعمة لم يشكر الله عليها ذنب، ومرور لحظة لا يراقب الله فيها، ولا يخافها ذنب، وكل مخالفة لأمر الله وإن صغرت ذنب، وأعضاء البدن كلها جوارح، فالقلب جارحة، وهو أعظم الجوارح، والعين جارحة، والسمع جارحة، واليد والرجل واللسان والأنف [فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأنف يزني وزناه الشم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه].
والسؤال يوم القيامة عن عمل كل الجوارح. قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولاً}.
والسؤال عن الغمزة واللمزة والهمزة، واللفظة، بل وخطرات القلوب، وأحاديث النفوس، وخفايا الصدور، وفلتات الألسنة: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} {قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله} {يوم تبلى السرائر* فما له من قوة ولا ناصر} {ويل لكل همزة لمزة} {فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}.
والمؤمن يعيش وهو يحمل هم ذنوبه ومعاصيه، ولا تزال شخوصها تؤرقه بالليل والنهار، وهذه إحدى همومه!!
هم الخاتمة:
والهم الثاني الأكبر الذي يحمله المؤمن هم الخاتمة، ولحظات النهاية، وساعة الغروب!! وذلك أن على هذه الساعة الأخيرة يتوقف المصير، وتكون الجنة أو النار، وقد يكون الشوط كله عند الساعة الأخيرة في الخير ثم تكون الخاتمة شراً وكفراً عياذاً بالله من سخطه وعقوبته، وقد يكون الشوط كله شراً أو كفراً ثم تكون الساعة الأخيرة إيماناً ويقظة وعوداً إلى الله فتكون الخاتمة السعيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد..
فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها] (متفق عليه).
القبر أول الهموم:
وهموم ما يأتي هموم ثقيلة وليس شيئاً منها مظنوناً بل هي هموم وغموم مقطوع بها لا محيد عنها ولا مفر منها فأولها القبر، وهل من القبر مفر؟! وهل لأحد منه مهرب؟ والقبر ما هو؟
إنه بيت الظلمة والضيق، والدود والنتن والوحدة؟! إن أخلص أصدقائك، وارحم خلانك وخاصة أهلك هم من يهيلون التراب عليك، ويحكمون سد القبر خلفك، ويلون ظهورهم لك، ويتركوك وحدك!! وقد قال صلى الله عليه وسلم: [وإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم] اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك المجتبى ورسولك المصطفى
الفزع الأكبر:
وكل هذه الهموم تصغر إذا ذكر الهم الأعظم، وجاء ذكر الفزع الأكبر، إنه النار التي لا محيد لمؤمن عن ورودها، والعبور على الصراط فوقها: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً}.
لا أمن إلا لأهل المخافين:
والحال أنه لا أمن إلا لأهل الخوف. قال تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك الفوز العظيم} فأهل الإيمان والتقوى: مخافة بالليل والنهار، وهؤلاء هم الذين ينفي الله عنهم الخوف مما هم مقدمون عليه والحزن مما خلفوه وراء ظهورهم، ولا تكون هذه البشرى المقطوع بها إلا عند الموت قال تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم}.
وتنزل الملائكة على هؤلاء إنما يكون عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بحنوط من الجنة ويأخذون روحه من يد ملك الموت فيحنطوها بذلك الحنوط ويكفونها بذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء التي فيها الله!! ويبشرون بالجنة.
وفي الجنة تكون أول كلمات أهل الإيمان التي يقولونها {الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور}.
فلقد كانت حياتهم في الدنيا أحزاناً أثر أحزان وهموماً تتبعها هموم، وغم يتلوه غم، وهم في كل حياتهم خائفون مشفقون.
وعندما يجلس أهل الجنة أول مجالسهم في جنات النعيم على سرر متقابلين يقبل بعضهم على بعض بعد مجلس شراب تنازعوا فيه الكئوس، ودارت عليهم بها الغلمان المخلدون كأنهم اللؤلؤ المكنون يقول بعضهم لبعض {قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم} (الطور:26-28).
وبينما هم كذلك في سرورهم وحبورهم ولذتهم وطعامهم وشرابهم ونسائهم يكون أهل النار في صراخهم وعذابهم يدعون على أنفسهم بالهلاك والثبور لأن جريمتهم أنهم أمضوا حياتهم مسرورين فكهين لا يحملون هماً ولا غماً: {وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فإنه يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور}.
[gl] بقلم الشيخ :عبدالرحمن بن عبدالخالق [/gl]